في 20 مايو 2025، وللمرة الثانية في تاريخ باكستان الممتد على مدار 77 عامًا، حصل قائد عسكري على رتبة مشير رفيعة. بالنسبة للجنرال سيد عاصم منير أحمد شاه، تُعدّ هذه الترقية تتويجًا لطموحاته. ومع ذلك، كان هذا الحدث أيضًا تأكيدًا رمزيًا على التفوق العسكري في ظل نظام سياسي هش.
لطالما كانت باكستان دولةً بريتوريةً نموذجية: نظامٌ سياسيٌّ تُضعف فيه المؤسسات السياسية من قدرتها على احتواء أو توجيه سلطة الجيش، والذي، كونه القوة المتماسكة الوحيدة، يتقدم مرارًا وتكرارًا لفرض النظام. إنه نمطٌ لم ينشأ عن صدفة، بل هو نموذجٌ لدولةٍ تشكّلت بنيتها المؤسسية في ظلّ المركزية الاستعمارية، وتوقف تطورها السياسي قبل أن تتجذّر المعايير الديمقراطية.
لم يكن صعود الجنرال منير إلى رتبة مشير مجرد صعود جندي، بل كان تتويجًا لنظام. تُجسّد مسيرته المهنية – التي امتدت لقيادة كل من الاستخبارات العسكرية وجهاز الاستخبارات الداخلية (ISI) – اندماج المراقبة والرواية الدينية والقيادة الاستراتيجية التي تُعرّف الجيش الباكستاني الآن. إنها قوة لم ترَ قط أن واجبها الأساسي هو مجرد حراسة حدود البلاد؛ بل رأت نفسها حارسًا لحدود باكستان الأيديولوجية . في خطابه في 16 أبريل، كان تركيز الجنرال منير على التقسيم، ونظرية باكستان (“فكرة باكستان”)، ونظرية الدولتين، وفي نظره، المعركة الأبدية بين الهندوس والمسلمين.
تأسست الدولة الجديدة كديمقراطية، وحافظت النخبة المؤسسة لها على بنية السلطة الاستعمارية وعززتها. وقد أدى التركيز المتزايد على التوازن المؤسسي إلى أن يملأ التماسك التنظيمي للجيش فراغًا خلّفته الأحزاب السياسية الضعيفة، والبيروقراطية المتجذرة، والهيئات التشريعية التي فقدت مصداقيتها، والقضاء المُسيّس.
على مدى 77 عامًا مضت، وظّف الجيش الباكستاني كل تدخل، سواءً كان حكمًا مباشرًا أو غير مباشر، على أنه إنقاذ للنظام القائم. أيوب خان، ويحيى خان، وضياء الحق، وبرويز مشرف، كلٌّ منهم يُصقل فن الحكم العسكري. حتى الآن، في ظل حكومة مدنية اسميًا، لا يقع مركز السلطة في برلمان إسلام آباد، بل في قاعات راولبندي المحصنة، حيث مقر الجيش. باكستان مبنية على هذا التناقض – غير المستقر وغير المستدام – حيث يدّعي مركز شرعيته ويمارسه مركز آخر.
شرعية الجيش مرهونة بوهم النظام والاستقرار. وبإظهاره صورةً من ضبط النفس والهدف الوطني، عزل الجيش نفسه عن المساءلة حتى مع تراجع المؤسسات المحيطة به. ما نسيه الجيش، أو اختار تجاهله، هو أن الدولة تحتاج إلى مؤسسات مختلفة تعمل معًا في نظام واحد. لا يستطيع الجيش، ولن يستطيع، إدارة كل شيء في باكستان، حتى لو حاول القيام بذلك على فترات منتظمة، أحيانًا بشكل علني، ودائمًا بشكل سري.
لم يُحوّل التدخل العسكري المفرط باكستان إلى دولة قوية؛ بل ربما يكون المصطلح الأنسب هو دولة هشة. المجتمع الباكستاني مُجزّأ على أسس عرقية ولغوية. نظامه السياسي أجوف ومتطرف، واقتصاده في حالة ركود.
لقب المشير نفسه يُحاكي أيوب خان، رجل الدولة العسكري النموذجي الذي تميّز عهده بتأسيسية واضحة للحكم العسكري. لكن بينما أعلن خان سلطته بصراحة – أصبح قائدًا للجيش عام ١٩٥١، ورئيسًا عبر انقلاب عام ١٩٥٨، وحكم حتى استقال عام ١٩٦٩ – فإن سلطة منير تكمن في غموضها. الجيش الباكستاني الحديث لا يُسقط الحكومات المدنية، بل يُصنّعها. لا يُلغي الانتخابات، بل يُهندِس نتائجها. لا يُمارس الرقابة بشكل علني، بل يُدبّر السرديات. المأساة لا تكمن في الانقطاع، بل في الاستمرارية المُقنّعة بزيّ الإصلاح.
لا يزال موقف الجيش من المعارضة الداخلية ثابتًا، سواءً أكان تمرد البلوش أم مطالب البشتون والسند بحقوقهم. وتُعتبر جميع هذه المطالب غير مفهومة في بلد متنوع عرقيًا ولغويًا، بل أعمال خيانة مدعومة من جهات خارجية، وتحديدًا الهند وأفغانستان .
إن ردّ الجيش على أي بادرة معارضة ليس التدخل، بل التصفية – وهو ما تم تقنينه الآن بموافقة المحكمة العليا على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهو تطبيع مُقلق للفقه الاستبدادي. يُعدّ هذا الاستقطاب القضائي جزءًا من نمط أوسع: فقد شهدت فترة حكم منير تدخلًا عسكريًا مُوسّعًا في الصحافة والمحاكم والعملية الانتخابية . في هذا المناخ، يُعاد تعريف السيادة نفسها: ليس كسيادة قانونية مُتجذّرة في القانون، بل كسيادة سياسية مُتجذّرة في القوة.
في أي بلد، تُعدّ الدولة الكيان الوحيد الذي يحتكر استخدام القوة. فبمجرد أن تسمح الدولة للجهات الفاعلة غير الحكومية باستخدام الأسلحة، فإنها تُقايض الشرعية بمصالح قصيرة الأجل. منذ عام ١٩٤٧، وخاصةً منذ سبعينيات القرن الماضي، اعتمدت المؤسسة العسكرية الباكستانية على الجماعات الجهادية كأدوات لسياستها الخارجية الإقليمية، وخاصة تجاه الهند وأفغانستان.
خوفًا من عجز باكستان عن الحفاظ على تفوقها العسكري التقليدي على الهند، وخاصةً بعد عام ١٩٧١، أضاف الجيش الباكستاني بُعدين إلى سياسة الردع الخاصة به: الأسلحة النووية، والأسلحة شبه التقليدية أو الحرب بالوكالة. وبينما تسببت الهجمات الإرهابية التي شنتها جماعات متمركزة في باكستان داخل الهند في خسائر أرواح وأضرار جسيمة، فإن رد الفعل على باكستان والباكستانيين كان أشد وطأة. ومع ذلك، وكما حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون نظيرها الباكستاني عام ٢٠١١: “لا يمكنك الاحتفاظ بالثعابين في حديقتك الخلفية وتتوقع منها أن تلدغ جيرانك فقط”، مؤكدةً بذلك على الأوهام القاتلة للدول التي دمرتها الوحوش التي خلقتها بنفسها.
لقد تحوّلت مناورة الجيش، مستغلاً وكلائه لتعزيز العمق الإقليمي، إلى عبئ استراتيجي. ففي نظر الكثيرين حول العالم، تُعتبر باكستان دولةً تؤوي الإرهابيين. وبينما قد يرفض الخطاب المحلي الباكستاني هذا الأمر باعتباره دعاية غربية أو هندية، فإنه سيُضطر عاجلاً أم آجلاً إلى مواجهة الواقع.
إن كان للتاريخ عبرة، فهو يُذكرنا بأن لا شيء مُقدّر. لقد تعثرت الأمم، أحيانًا بشكل كارثي، لتجد في داخلها القدرة على التجديد. بعد سبعة وسبعين عامًا من تأسيسها كديمقراطية، يجب على صانعي القرار في باكستان إعادة النظر في مسارهم المستقبلي. إما أن يتجهوا أكثر نحو الحكم العسكري أو يعودوا إلى الفيدرالية الدستورية.
المصدر: أبارنا باندي وفيناي كورا – ناشيونال انترست




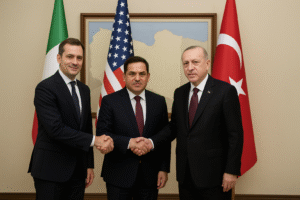



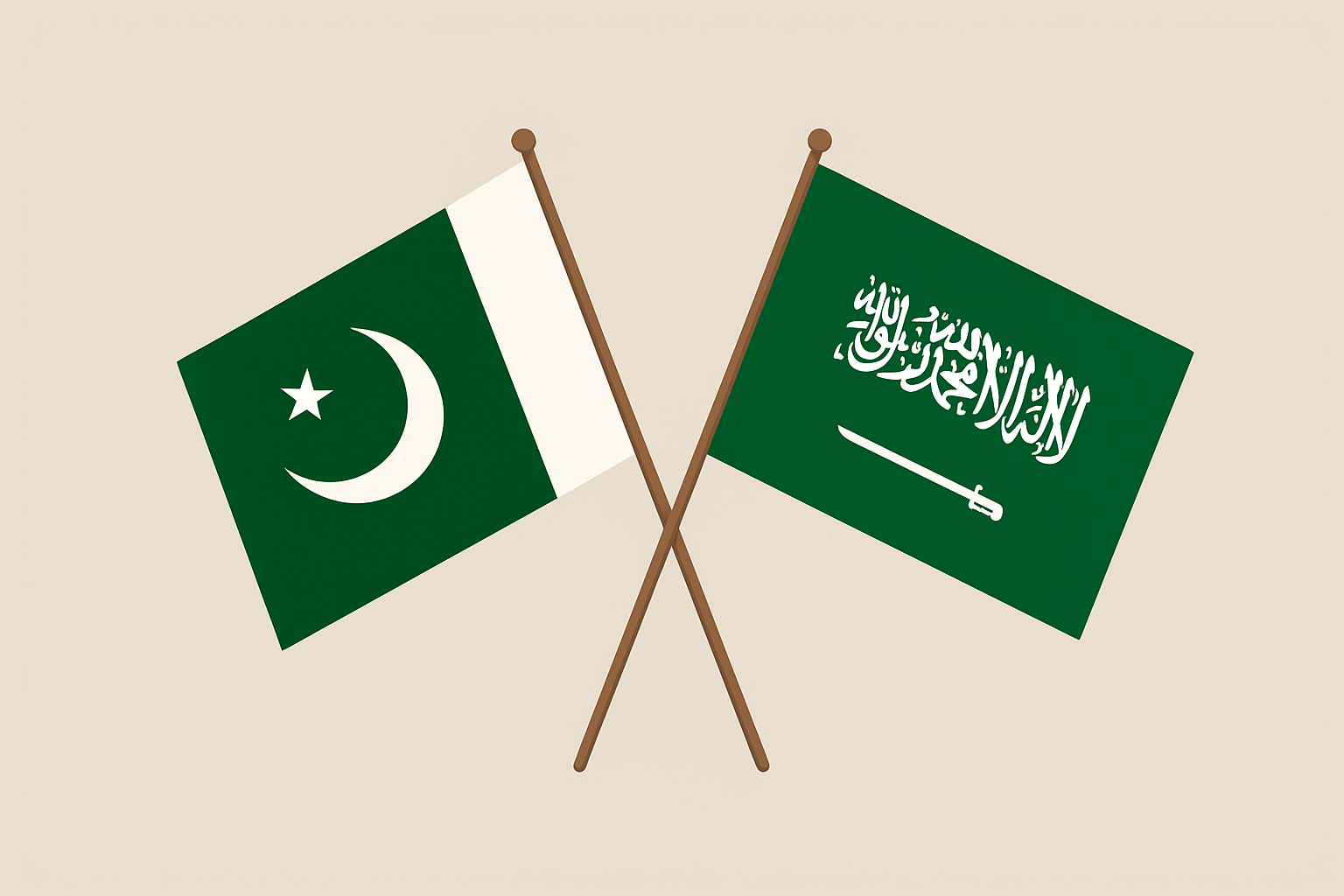
اضف تعليق