إن إراقة الدماء الطائفية التي اندلعت في السويداء ليست مجرد صراع محلي، بل هي إخلال بالمنطق الجيوسياسي لسوريا في مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد.
تُشير الاشتباكات بين الجماعات الدرزية والميليشيات الموالية للحكومة إلى تحول أعمق في ديناميكيات القوة الداخلية والتحالفات الإقليمية. في منتصف يوليو/تموز، اندلعت أعمال عنف في أنحاء محافظة السويداء بعد أن شنت جماعات مسلحة مرتبطة بالحكومة السورية – يتألف العديد منها من مقاتلين بدو وعشائر – هجمات منسقة على المناطق الدرزية. وأفادت التقارير أن بعض المهاجمين صوّروا أنفسهم وهم يطلقون النار على المدنيين، مما حوّل الهجوم إلى استعراض للإفلات من العقاب واستفزاز. وما تلا ذلك كان أعنف اندلاع للعنف تشهده المحافظة منذ سنوات، مخلفًا عشرات القتلى وأحياء بأكملها تحمل ندوب الصراع – جدران مثقوبة بالرصاص، وقرى ومنازل محترقة، وعائلات تبكي خسائرها في صمت.
مع تصدي المقاتلين الدروز، نزح آلاف المدنيين البدو إلى القرى المجاورة، وتم التوصل في النهاية إلى هدنة هشة. لكن تحت وطأة هذه الهدنة الهشة، بدأت الحسابات الاستراتيجية والعقد الاجتماعي الذي حافظ على السويداء بمعزل عن الصراع السوري الأوسع بالتفكك، مما أثار تساؤلات جديدة حول الدور المستقبلي للمحافظة في المشهد السوري الممزق.
مع ذلك، فإن تفكك السويداء ليس مجرد مؤشر على تفكك سوريا الداخلي، بل هو أيضًا انعكاس لتحولات في الاستراتيجيات الإقليمية. لم تكتفِ الجهات الفاعلة الإقليمية بالاستجابة لأحداث السويداء، بل ساهمت في تشكيلها. يعكس توسع دور إسرائيل في الجنوب، والتوافق الاستراتيجي لتركيا مع دمشق، والدعم السعودي والأردني للسيطرة المركزية، حسابات جيوسياسية متطورة. لقد بلورت السويداء تجزئة البلاد إلى مناطق ذات استقلال سياسي وعسكري، مما دفع سوريا أكثر نحو نموذج مراكز حكم منفصلة، تتشكل من التحالفات الأجنبية بقدر ما تتشكل من الشرعية المحلية، أو غيابها.
داخليًا، تُبرز أزمة السويداء المُتفاقمة كيف تُعيد فراغات السلطة المحلية تشكيل الجغرافيا السياسية لسوريا. فعلى عكس الساحل – حيث حافظ الرئيس أحمد الشرع، على الأقل حتى الآن، على سلطته الرسمية ومنع المزيد من الاضطرابات بعد موجة من المجازر الطائفية التي استهدفت العلويين في مارس/آذار، عقب كمين نُصب للقوات الحكومية من قِبل مُعارضين – خالفت السويداء هذا التوجه. ففي أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على القوات السورية في السويداء ومحيطها دفاعًا عن الدروز، إلى جانب ضربة مباشرة على مقر الجيش السوري في وسط دمشق، توسطت الولايات المتحدة وتركيا وعدة دول عربية في هدنة بين الفصائل . وأعلنت الأسبوع الماضي وقفًا لمعظم القتال.
أدى وقف إطلاق النار، وما تلاه من انسحاب القوات الحكومية السورية والغضب الشعبي الواسع إزاء عمليات القتل الأخيرة، إلى تعزيز مكانة الشيخ حكمت الهاجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا. ورغم أنه كان شخصية مثيرة للجدل في السابق ، تنافس مع مراجع دينية درزية أخرى وقاد طائفة منقسمة سياسيًا، إلا أن الهاجري برز الآن كأبرز أصواتها . ويُنظر إليه بشكل متزايد على أنه الشخص الذي أمّن الحماية الإسرائيلية وساعد في منع استمرار ما خشي الكثيرون أن يصبح مذبحة على أيدي مقاتلين من العشائر والموالين للحكومة، مما أكسبه مكانة البطل بين شرائح واسعة من الدروز. وفي خروج دراماتيكي عن الحذر السابق، تُعلن شرائح واسعة من الدروز السوريين الآن علنًا عن استعدادها لقبول ضمانات أمنية من جهات خارجية، بما في ذلك إسرائيل، مما يُبرز عمق التحول المحلي في النظرة تجاه دمشق.
وقد قللت هذه الديناميكية الجديدة من احتمالية التوصل إلى تفاهم سوري-إسرائيلي، الذي كان الكثيرون يعتقدون حتى وقت قريب أنه في متناول اليد. في الوقت نفسه، أثار تغيّر نظرة الدروز لإسرائيل احتمال نشوء منطقة عازلة داخل سوريا بين إسرائيل ودمشق، مما زاد من تعقيد الحسابات الاستراتيجية للنظام. ومع ذلك، خارج السويداء، ترسخت أيضًا النظرة السورية لإسرائيل. ينظر العديد من السوريين الذين تحدثت معهم الآن إلى إسرائيل كقوة تسعى إلى تفكيك البلاد وإخماد أي أمل في السلام أو المصالحة أو إيجاد مخرج من حرب سوريا الطويلة.
كشفت أزمة السويداء أيضًا عن تباين مصالح الأطراف الإقليمية الفاعلة، حيث أعاد كلٌّ منها ضبط نهجه تجاه مستقبل سوريا. وقد ساهمت إسرائيل، أكثر من أي طرف آخر، بشكل مباشر في تشكيل الديناميكيات على الأرض. فمن خلال استهدافها للأسلحة الثقيلة السورية في الجنوب، وتحذير دمشق من إدخال معدات جديدة، والانحياز إلى الجماعات المسلحة الدرزية، تُحوّل إسرائيل فكرة المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية إلى واقع استراتيجي. ويعكس هذا النهج استراتيجية إسرائيلية أوسع نطاقًا: إبقاء السلطة في سوريا محل نزاع، وردع الجهات التي لا تستطيع السيطرة عليها مركزيًا، ومواجهة عودة النفوذ الإيراني.
في المقابل، ينظر الأردن إلى استقلال السويداء المحتمل على أنه تهديد أمني خطير. ورغم أن المحافظة تقع على حدود الأردن، إلا أنه لا يوجد معبر رسمي بينهما. ولا تزال عمان تشعر بالقلق من ظهور جيب لا يمكنها الوثوق به أو التأثير عليه أو تنظيمه، وخاصةً إذا كان قد يتحالف مع إسرائيل. وقد أدى تهريب المخدرات والأسلحة ، وهو مصدر توتر أصلاً، إلى تفاقم المخاوف، لا سيما مع تقاطع الشبكات القبلية داخل الأردن مع ديناميكيات الصراع في جنوب سوريا. ولطالما فضل الأردن العمل مع الدول المركزية، وعارض باستمرار الجهات الفاعلة غير الحكومية وتطلعات الحكم الذاتي قرب حدوده.
في غضون ذلك، دعمت المملكة العربية السعودية جهود دمشق لاستعادة سيطرتها على السويداء ، معتبرةً الحفاظ على وحدة أراضي سوريا أمرًا أساسيًا لاستقرار المنطقة من خلال منع عودة إيران إلى سوريا ومنع المزيد من الفوضى في بلاد الشام. ومثل تركيا والأردن، تعارض الرياض التشرذم، وأعربت عن إحباطها من توسع دور إسرائيل في الجنوب، وهي لحظة نادرة من التقارب بين المملكة العربية السعودية ومنافستها الإقليمية، تركيا.
مع ذلك، لا تزال السعودية متشككة في النفوذ التركي على دمشق، وهو قلق دفع الرياض إلى زيادة دعمها للشرع سعيًا لإبقائه راسخًا في الحضن العربي. وتدرك الرياض بلا شك أن تكثيف الهجمات الإسرائيلية على دمشق قد يدفع الحكومة السورية إلى التقارب مع أنقرة، مما قد يؤدي إلى تنامي الوجود العسكري التركي في جميع أنحاء سوريا كقوة موازنة للضغط الإسرائيلي – وهي نتيجة تسعى الرياض جاهدةً لتجنبها. ولا يقتصر قلقهم على تزايد خضوع سوريا للنفوذ التركي فحسب، بل يشمل أيضًا احتمال نشوب مواجهة تركية إسرائيلية قد تزيد من زعزعة استقرار المشهد الإقليمي الهش أصلًا.
لا يوجد مكانٌ يتجلى فيه التباين الاستراتيجي في سوريا أكثر وضوحًا من التباين بين إسرائيل وتركيا. فبينما لا تزال الدولتان منشغلتين بشدة برسم النتائج على الأرض، إلا أن رؤيتيهما لمستقبل سوريا تتباينان بشكل متزايد.
تعمل إسرائيل على إبقاء السلطة مجزأة، معتبرةً اللامركزية ضمانةً ضد مركزية الجماعات الإسلامية أو صعود تحالفٍ غير متوقع قد يتراجع عن التزاماته مستقبلًا. ويعكس نهج إسرائيل في السويداء استراتيجيتها الأوسع: تمكين الجهات الفاعلة المحلية واحتواء التهديدات القريبة من خلال التدخلات العسكرية.
على النقيض من ذلك، ألقت تركيا بثقلها خلف الحكومة المركزية في دمشق، وعرضت الدعم الدبلوماسي ووسعت التعاون الاقتصادي . ترى أنقرة في قيادة الشرع حصنًا ضد قوات سوريا الديمقراطية (SDF) المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها تركيا امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK) الذي تم تفكيكه مؤخرًا – وهي جماعة تصنفها كمنظمة إرهابية. تعتقد أنقرة أن إعادة تنشيط الدولة السورية – وخاصة تلك التي يمكنها التأثير عليها – هي الطريقة الأكثر فعالية لقمع الزخم من أجل الحكم الذاتي الكردي ، وتقليل الدعم الأمريكي للقوات الكردية بالقرب من حدودها الجنوبية. كما تخشى تركيا من أن تستغل الفصائل الكردية في سوريا الاضطرابات في الجنوب للتعبئة السياسية والعسكرية، باستخدام التشتيت لتعزيز تطلعاتهم إلى الحكم الذاتي.
بينما أعادت إسرائيل وتركيا فتح قنوات دبلوماسية بينهما بحذر، لا تزال سوريا نقطة خلاف رئيسية. يختلف الجانبان ليس فقط حول شرعية حكم الشرع، بل أيضًا حول طبيعة النظام السياسي المطلوب في سوريا للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي. في الواقع، تُعزز إسرائيل التشرذم كشكل من أشكال الأمن، بينما تسعى تركيا إلى المركزية كمسار نحو سوريا مستقرة لا تُصدّر التحديات الأمنية الكردية. ومن المرجح أن يتعمق هذا التباين مع سعي كلا البلدين إلى تشكيل نظام ما بعد الصراع وفقًا لشروطهما الخاصة.
بالنسبة للحكومة السورية بقيادة الشرع، كشفت أزمة السويداء عن محدوديتها، وأوضحت تحالفاتها الإقليمية. ولا تزال السيطرة على السويداء، في الوقت الراهن، احتمالاً بعيداً. يفتقر النظام إلى الشرعية والقدرة العسكرية لإعادة فرض سيطرته في الجنوب دون إثارة مقاومة أوسع. وبدلاً من ذلك، يعتمد الشرع دبلوماسياً على داعميه الإقليميين – وخاصة تركيا والأردن والسعودية وقطر – لتعزيز سلطته وتقديم الدولة على أنها الضامن الوحيد لوحدة أراضيها. وتتجنب استراتيجيته التفاوض المباشر مع القادة المحليين الناشئين، مثل الهاجري، مما يشير إلى رفضه إضفاء الشرعية على أي جهة تعمل خارج المؤسسات الرسمية.
يبقى الاستثناء الوحيد قوات سوريا الديمقراطية، التي يتطلب دعمها الأمريكي تفاعلًا خاصًا. ولكن حتى في هذه الحالة، تقاوم الحكومة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية كندٍّ سياسي، مفضلةً حصر الحوار في مسائل التنسيق الأمني بدلًا من الإصلاح الدستوري أو الإقليمي. وبشكل أعم، يُعطي نهج الشرع الدبلوماسي الأولوية للعواصم الأجنبية على التوافق الداخلي – مُشركًا واشنطن وأنقرة وتل أبيب، مع تجنب أي حوار داخلي حول مستقبل حكم سوريا. إنها استراتيجية مُصممة للحفاظ على مظهر الدولة، حتى مع استمرار تآكل تماسكها الداخلي.
لن تُحدد انتصارات المعارك أو بيانات القمم ما سيحدث في سوريا لاحقًا، بل ستُحدده تطورات الواقع الميداني، واستعداد الأطراف الإقليمية والدولية للتكيف معه. لقد شكلت أزمة السويداء النهاية الرسمية للصراع الثنائي الذي ميّز سوريا وشكّل الأحداث على الساحل: النظام في مواجهة المعارضة. وحلّ محله واقعٌ متعدد الطبقات ولامركزي، تشكّله تحالفات متغيرة، ومناطق نفوذ متداخلة، ومطالبات متنافسة بالشرعية. لم تخرج سوريا من حكم الأسد الذي دام عقودًا ككيان واحد قابل للحكم، بل كمنطقة مجزأة من مناطق شبه مستقلة، وترتيبات بوساطة خارجية، ومراكز حكم منفصلة.
بالنسبة للولايات المتحدة وغيرها، يكمن التحدي الآن في تجاوز الأطر البالية التي تُعلي من تماسك الدولة على حساب الاستقرار السياسي. إن الشرعية والموافقة المحلية والتنسيق الإقليمي – وليس القوة أو الاعتراف الرسمي وحدهما – هي ما سيحدد المرحلة التالية من التحول في سوريا. يتطلب استقرار سوريا فهمًا إقليميًا أوسع، فهمًا يُقر بدور الدول المجاورة في تحديد النتائج ويمنع التصعيد بينها. مع تزايد تواجد إسرائيل العسكري داخل سوريا، يتزايد خطر إعادة إحياء الصراع الإقليمي – وهو سيناريو يجب تجنبه. سواء كان الهدف هو الاستقرار أو إعادة الإعمار أو منع الصراع، فإن أي سياسة جادة يجب أن تبدأ بالاعتراف بأن مركز سوريا لن يصمد – وأن أطرافها هي التي تُحدد مستقبل البلاد.
إبراهيم الأصيل -أتلانتك كانسل





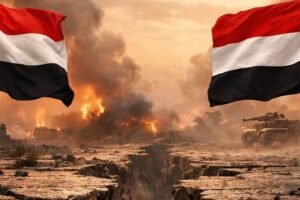


اضف تعليق