شهدت “حرب الاثني عشر يومًا” بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025 أكبر مواجهة عسكرية مباشرة بين الخصمين الشرق أوسطيين اللدودين منذ عقود، ودفعت الولايات المتحدة للتدخل بضرب المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية في فوردو ونطنز وأصفهان بقنابلها الخارقة للتحصينات. ورغم وصف الرئيس دونالد ترامب للعملية التي سعت إلى تقويض قدرات إيران النووية على التخصيب بأنها انتصار شامل، وإعلانه وقف إطلاق النار في 24 يونيو/حزيران، إلا أن الخطر النووي لا يزال قائمًا، ومعه شبح تصعيد إقليمي قد يزعزع استقرار أسواق الطاقة، ويرفع أسعار النفط، ويوجه ضربة قاصمة لأمن الطاقة العالمي.
أشارت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى أن أجهزة الطرد المركزي ربما لا تزال سليمة تحت الأنقاض في المواقع الثلاثة المذكورة، بينما حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنها لا تستطيع تحديد موقع 410 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والذي يُرجح أنه أُزيل قبل الحرب، والذي قد يكفي لصنع عشرة رؤوس نووية. ومع استمرار الخطر النووي وتصورات التهديد المرتبطة به التي دفعت إسرائيل إلى شن هجماتها الأولية، لا يبدو أن طريق العودة إلى الحرب طويل، وتزداد أهمية التسوية البديلة يومًا بعد يوم.
إن جولة جديدة من القتال، وربما أكثر كثافة، ستفرض تكاليف باهظة على جميع الجهات الفاعلة التي لها مصلحة في الصراع، لا سيما في ضوء حقيقة أنه لا يمكن ضمان الحل العسكري. إن محادثات تغيير النظام في إيران، سواء بتسهيل من جهات خارجية أو ناشئة عضويًا من داخل المجتمع الإيراني، لا ترقى إلى مستوى الواقعية في الوقت الحاضر. في حين أن نسبة كبيرة من السكان تعارض الجمهورية الإسلامية ومظاهرات الحركة الخضراء منذ عام 2010، وحركة المرأة. الحياة. الحرية. في عام 2022 أثبتت أنها قادرة على زعزعة القيادة، لا يوجد تحالف موحد من أصحاب المصلحة يمكنه تنفيذ رؤية لشكل بديل للحكم. وعلى الرغم من الانقسامات الملحوظة بين المعسكرين المتشدد والإصلاحي في المؤسسة، فإن فيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) الملتزم أيديولوجيًا والمتعدد الأعراق يواصل دعم النظام. في ظل غياب السلطة المطلقة لآية الله علي خامنئي، قد يُشكّل الحرس الثوري الإيراني، الذي يبلغ قوامه 150 ألف جندي، وشبكة الميليشيات التابعة لإيران، الضعيفة ولكن الناجية، أساسًا لحركة مقاومة إقليمية، مما يُؤدي فعليًا إلى تفتيت أيديولوجية الجمهورية الإسلامية.
صراع مستقبلي غير مرغوب فيه
بالنظر إلى العلاقات القوية للولايات المتحدة مع إسرائيل ودول الخليج، ومصالحها الأوسع في استقرار أسعار الطاقة العالمية، فإن اندلاع جولة جديدة من الحرب سيجعل من غير المرجح امتناع واشنطن عن المشاركة. هذا الخيار يزداد رفضًا مع تزايد الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة ضد الانخراط في عملية عسكرية أطول أمدًا – أو حتى الانخراط عسكريًا من الأساس.
تهدد الحرب بقاء النظام الإيراني ذاته، وخلال الأعمال العدائية في يونيو/حزيران، أشارت طهران مرارًا وتكرارًا إلى تفضيلها لخفض التصعيد من خلال إعطاء تحذير مسبق بضربتها الانتقامية على قاعدة العديد الجوية الأمريكية – والتي ألمح إليها الرئيس ترامب – بالإضافة إلى إعلان استعدادها لوقف عمليتها العسكرية، إذا ردت إسرائيل بالمثل. إن حملة “الضغط الأقصى” التي تشنها الولايات المتحدة، والتي فضلها الرئيس ترامب منذ انسحابه من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) خلال ولايته الأولى في عام 2018، تجعل أي جهد إيراني لإعادة بناء قدرات الردع في البلاد صعبًا. سيكون هذا أكثر صعوبة في مواجهة إعادة فرض العقوبات على مستوى الأمم المتحدة بعد تفعيل الأوروبيين لآلية “العودة السريعة”. إن الخيار المتبقي للتخصيب النووي السري والسباق نحو القنبلة – حتى في ظل ضغوط اقتصادية هائلة – من شأنه أن يجذب حتمًا هجمات إسرائيلية (وربما أمريكية أيضًا).
مع ذلك، يُعدّ إعادة بناء قدرٍ من قوة الردع الإيرانية أمرًا ضروريًا للنظام، الذي تلقّى ضربةً موجعةً نتيجةً للهجمات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة في حرب الأيام الاثني عشر، فضلًا عن إضعاف “محور المقاومة” في أعقاب حروب إسرائيل على حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، بالإضافة إلى سقوط نظام الأسد في سوريا خلال العام الماضي. يجب تحقيق ذلك دون إثارة تصورات التهديد الإسرائيلية، بل ودون إثارة مخاوف الولايات المتحدة والخليج وأوروبا من اختراق نووي قد يدفع جميع الأطراف نحو نهج سياسي أكثر تشددًا.
ترتبط وسائل الردع المفضلة لدى إيران بجوهر انتقادات الرئيس ترامب وتخليه النهائي عن خطة العمل الشاملة المشتركة. فإلى جانب التركيز الرئيسي لاتفاق عام 2015 على الانتشار النووي، لم يُعالَج برنامج إيران لتطوير الصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها أعضاء “محورها” بشكلٍ كافٍ. إضافةً إلى ذلك، استُبعد شركاء الولايات المتحدة في الخليج، الذين يواجهون تهديداتٍ جسيمة من إيران، تمامًا من هذا الإطار. وفي ظل الوضع الراهن، ستطالب الولايات المتحدة بإنهاءٍ كاملٍ لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني، بما في ذلك استعادة مخزون اليورانيوم “المفقود”. ومن المرجح أن يكون منع إيران من إعادة تأهيل “محورها” نقطة خلافٍ أخرى لترامب. في المقابل، قد تطالب إيران بتنازلاتٍ معينةٍ لتمكينها من تطوير وسائل ردعٍ تقليدية، على سبيل المثال، بالتركيز على سلاحها الجوي الذي عفا عليه الزمن، وأنظمة الدفاع الجوي التي دُمرت في حرب الأيام الاثني عشر، وغيرها من الوسائل العسكرية. ومن المرجح أيضًا أن تكون التزامات الولايات المتحدة تجاه المجتمع الدولي بعدم التدخل أمرًا مرغوبًا فيه.
المفاوضات ودور الوسطاء
يعتمد المسار البديل للتوصل إلى تسوية تفاوضية بشكل حاسم على مشاركة الولايات المتحدة. قد تحاول المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تحفيز طهران على العودة إلى المفاوضات والامتثال لنظام تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تفعيل آلية “العودة السريعة”، التي تهدد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة الكاملة على إيران التي سبقت خطة العمل الشاملة المشتركة، بحلول نهاية سبتمبر. في الواقع، ستفشل دول الخليج، بما فيها عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية، التي أثبتت في مناسبات سابقة دورها الفعال في تسهيل المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، في إحداث تغيير حقيقي. فجهود الوساطة التي تبذلها هذه الدول لا تنفصل عن مكانتها كمصدرين رئيسيين للطاقة، يعتمد استقرارها الاقتصادي والسياسي على الحفاظ على تدفقات موثوقة للنفط والغاز عبر الخليج. فبدون دعم أمريكي قوي يمنع المزيد من التدخلات في إيران ويرفع العقوبات عن اقتصادها، لن يتحقق أي اتفاق.
أصبحت المفاوضات المباشرة غير واردة بالنسبة لطهران بعد أن انتهكت الولايات المتحدة سيادة إيران بضرباتها. هذا يجعل مشاركة الأطراف المعنية ضرورةً مُلحة في هذه المرحلة، كما أبرز تقريرٌ نُشر مؤخرًا عن منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قد لا تُقنع الدول الأوروبية والخليجية إيران بمفردها، لكن وساطتها قد تُمهّد الطريق لمحادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، خاصةً إذا أرسل الرئيس ترامب الإشارات الصحيحة. ستكون الصين وروسيا طرفين رئيسيين في هذه المرحلة، حيث لا يُعدّ دعمهما لاتفاق جديد ضروريًا فحسب بفضل حق النقض (الفيتو) الذي تتمتعان به في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بل يُمكنهما أيضًا أن يُوفرا تأثيرًا إيجابيًا إضافيًا على إيران.
نفوذ الصين وروسيا
إن اعتماد الصين الكبير على تدفقات النفط والغاز المستقرة من الخليج، إلى جانب مكانتها كأكبر مُستهلك للنفط الإيراني، يُوفر وضعًا مُفيدًا للغاية لدفع عجلة الاتفاق. هذا الاعتماد على طاقة الخليج يجعل بكين حساسةً بشكل خاص لأي اضطرابات، حيث إن عدم الاستقرار قصير المدى في مضيق هرمز قد يُؤدي إلى ارتفاعاتٍ حادة في الأسعار العالمية، مما يُؤثر بشكل مباشر على نمو الصين. من جهة، تكمن مصالح الصين أيضًا في تجنب جولة جديدة من الحرب من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. من جهة أخرى، يُنشئ اعتماد إيران على بكين في 90% من مبيعاتها النفطية، والتي استخدمتها طهران لتعويض خسارة الدخل الناتجة عن العقوبات الغربية الشاملة المفروضة عليها، تبعيةً يُمكن استغلالها. يُمثل دور بكين في تسهيل التقارب الإيراني السعودي في عام 2023 رابطًا إضافيًا من شأنه أن يُشجع دول الخليج على المشاركة في اتفاقية تسوية إقليمية جديدة. كما يدعم تعاون روسيا الوثيق مع دول الخليج في إطار أوبك+ هذه الحجة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تعاون روسيا العسكري والطاقة مع إيران، والذي تعمّق خلال حرب موسكو التي استمرت ثلاث سنوات في أوكرانيا، يُهيئها للمشاركة في إعادة بناء الردع الإيراني بوسائل تُستبعد الانتشار النووي. إن نفوذ موسكو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك+) يعني أنها تلعب دورًا مزدوجًا، ليس فقط في تشكيل الدبلوماسية الإقليمية، ولكن أيضًا في استقرار إنتاج النفط العالمي وأسعاره. يُشكّل هذا حافزًا لروسيا للمشاركة الفاعلة في المفاوضات. تُعدّ محادثات الرئيس ترامب الجارية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا أساسيةً في هذا الصدد، لكن هذا الارتباط بين القضيتين يضمن أيضًا أن يكون التقدم في الملف الإيراني مرتبطًا على الأرجح بالتنازلات المُقدّمة بشأن أوكرانيا.
الطريق الضيق للمضي قدمًا
بما أن الوضع الراهن الحالي تجاه إيران يُعرّف بارتفاع خطر الحرب، وأنّ الانخراط الدبلوماسي دون موافقة أمريكية لن يُؤدّي إلا إلى تأخير التصعيد، ولن يمنعه، فإنّ خيارات الرئيس ترامب السياسية تعود إلى منطق التفاوض على اتفاق. وبينما يبدو الطريق الضيق للمضي قدمًا، فإنّ الاعتبارات الاستراتيجية لكلٍّ من إيران والولايات المتحدة تُشير إلى إعادة الانخراط. ومن المُرجّح أن يُشكّل توجيه المحادثات الأمريكية الإيرانية عبر وساطة أوروبية و/أو خليجية، مع مراعاة المصالح والنفوذ الصيني والروسي، والحدّ من خطر الإجراءات الأحادية الجانب من جانب إسرائيل، الاختبار الأكبر لبراعة ترامب في إبرام الصفقات. بالنسبة لواشنطن، تتجاوز المخاطر الدبلوماسية: فتجنب اضطرابات أسواق الطاقة والحفاظ على استقرار أسعار النفط العالمية أمران أساسيان لأي تسوية دائمة. ونظرًا لأن الشرق الأوسط يُمثل أكثر من 30% من إنتاج النفط العالمي، فإن مخاطر تجدد الصراع تتجاوز بكثير السياسة الإقليمية لتصل إلى جوهر أمن الطاقة العالمي.
المصدر: باتريك كوراث -ناشوينال انترست


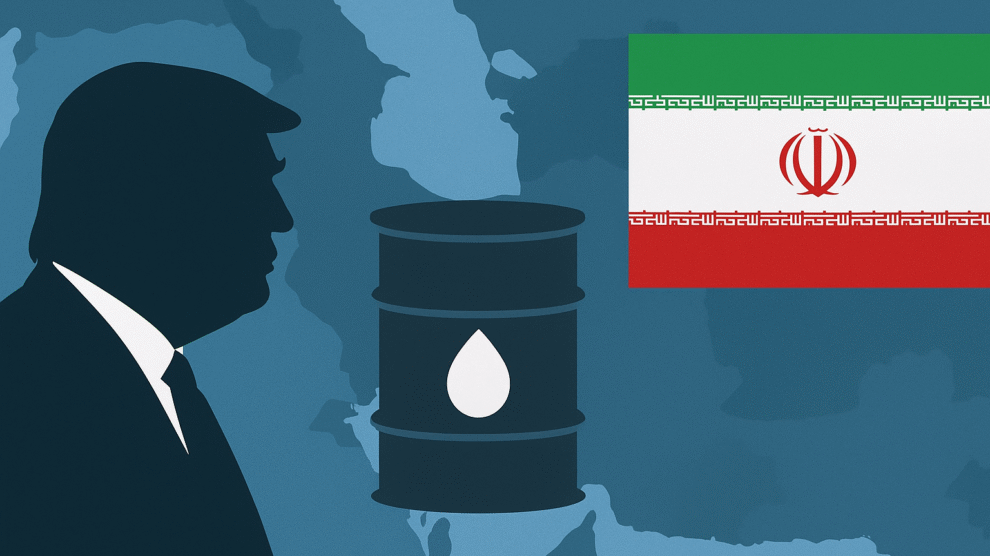

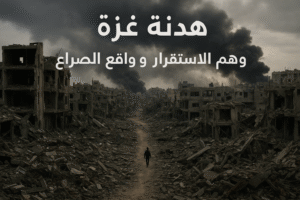




اضف تعليق